“ما تبقى من رمق الشفق” هو عنوان الأعمال غير الكاملة التي نشرتها في ثلاثة أجزاء تشتمل على اثنتي عشرة مجموعة شعرية صدرَتْ لي منذ 1975 إلى الآن. وبدءاً من العنوان يتّضح أن ثمة دلالتين مضيئتين في العمل، إحداهما زمنيّة مكانيّة ترسم الحركة في فضاء طبيعي وهي تقطع آخر مسافة لها لبدء مرحلة جديدة في سلم الأبدية. والدلالة الثانية فنيٌّة عدّتُها ألوان واستعاراتٌ ورموز تنقل الخطاب من السطح إلى الأعماق. الشّفَقُ ليس سوى حمرةٍ ساحِرة يُشكّلُها ما يتبقّى من شمس غاربة. لكن، ألا يمكن اعتبارُهُ جسراً يربطُ بين النّهار والليل؟ وإذا أردنا إسقاطاً تخييليا، أليس هو هذه الحياة العبثية التي تحترق تدريجياً مقتربةً من الغَوْص بلا رجعة في الظّلموت، أعني بحرَ المجهول، فيكون الشّفق آنئذ نقطةَ تقاطعٍ بين شموخ العُنفوان وهشاشة الوَهَن؟ أو بلغة أوضح وأكثر شجاعة، ألا يكون الشفق، بين السّبعين والثمانين حولا من عمر الشاعر، تنازعاً هادئاً بين عواصف الموت ونسائم الحياة؟
هي أعمالٌ شعرية غير كاملة، وليستْ كاملة. ليستْ جماع ما كتبته، أو ما قد أكتُبه بعدها، والحال أنني لحدّ السّاعةِ أعثُرُ على نصوص منسيةٍ لم تتضمّنْها أيّ مجموعة منشورة، أو أعثر على تصحيحات تتراوح بين حذف وتنقيح وإضافة (جمل، مقاطع، تقطيع…) قمتُ بها سابقا وظلّتْ مختفية في مجلدات الحاسوب، أو الخزّانات الإلكترونية، أو حتى في نسخٍ ورقية، ولم ألتفتْ إليها صدفةً إلا بعد إصدار العمل. وهذا دليلٌ على أن نصوصي منفتحةٌ انفتاحاً يسمحُ كلّ آنٍ بالتدخّل في معالجة أعطابها، ويؤكّد، لحسن الحظّ أو لسوئه، أنها لن تستويَ نهائيا إلا بعد مغادرة هذا العالم. وفضلاً عن ذلك، فإنّ علاقتي بالكتابة باعتبارها رافدا حيويا للحياة يحفزني على مواصلة جنونها في ما تبقّى من هذه الرّحلة المتناقضة متشبّثاً بـ”إرادة القوة” الإبداعية (بمفهوم نيتشه) إلى آخر نفس، مُعتبراً أنّ الإبداعَ لا يشيخُ طالما أسعفَتِ المبدعَ ظروفُهُ الصّحية والعقلية، ووجَدَ من الشّروط الملائمة ما يساعدُهُ على ذلك، وهو ما أتمنّاه على أيّ حال.
وفضلاً عمّا يشي به العنوانُ الرئيسيّ من دلالاتٍ زمانيةٍ ومكانيةٍ وفنيةٍ، فإنّني وضعتُ لكلّ جزء من الأجزاء الثلاثة عنواناً فرعياً يمكن اعتباره مبيانا لتطور التجربة وتوصيفا مختزلا لما يطبَعُ المرحلة التي كُتِبَتْ فيها قصائدُها، من طموحاتٍ وانشغالاتٍ جمالية، وما رسمته من حدود رؤيوية ليس للكتابة فقط بل للتلقّي أيضا.
أعزف على مقام القبول في الجزء الثالث الذي يضمّ البواكير دلالةً على تسليمي في هذه المرحلة بمفاهيم الشعر المعطاة إما وفقاً لمواصفات عمود الشعر، أو وفقا لتوجيهات شعر حركة البعث والإحياء النّهضوي، أو حركة الحداثة العربية الأولى التي أقامتْ نازك الملائكة صرحها النظري، وأقبل بما تقترحه إضاءاتُها النقدية والنظرية كأنه الحقيقة الوحيدة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
ومع ذلك فإن قراءة مقام القبول (الجزء الثالث) لَتُؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاعتقاد بذوبان شعرية النص الشّعري السّبعيني في الأيديولوجيا اعتقادٌ يجانب الصّواب ويحتاج إلى مراجعة، فهو موقف مُغالٍ إما لكون أصحابه يلغون بوعي بريء كلّ نص شعري ينغمسُ في حمم السّياسة ويواجهُ براكين الواقع، ويجرده من كل قيمة شعرية. وإما لكونهم يرغبون في إحالة كلّ كتابةٍ إلى كتابةٍ صمّاء، تجريدٍ محض، أو شعرٍ صافٍ لا ينصتُ لنبض الواقع ويتنكّر لفاعلية الحوار مع الإبداع حواراً جمالياً لا يلغي هويّة النّصّ الشّعري، وينكر على الشاعر امتلاكَ مشاعرَ إنسانيةٍ تجعله يتألّم حينما يستأسدُ الظلم، ويصول الفقر، وتنهار القيم، مثلما يفرح تماما وهو يرى وردةً تتفتح، أو بسمةَ رضيعٍ في المهد، أو عناقَ نجمتين عاشقتين في ليلة مقمرة.
وأما الجزء الثاني فأعزف فيه على مقام السّؤال، هذا السؤال الذي ظلّ يطرح منذ البدايات لكنه كان يرتدّ دائما إلى جبهة القبول، ربما لأن ترسانتي النقدية، وتجربتي الشعرية لم تكونا تسعفاني على الاستناد بقوة إلى حججٍ تسوّغ الاستمرار في التّساؤل، كما سيحدث في هذه المرحلة التي تعزّزت بأدواتٍ معرفية قادرة على تطوير السّؤال مدجّجةً بترسانة معرفية نضجت من خلال إعداد دراستيَّ “خمائل في أرخبيل، قراءة في الخطاب الميتالغوي عند أدونيس” و”تحولات تموز في شعر محمود درويش”، وقراءات أخرى ساعدتْ على الخروج من الشّرنقة، وتسويغ التشكيك في ما تقدّم من تصوّراتٍ تكرّسُ واحديةَ مفهوم الشعر وإلغاء ما عداها من مفاهيم.
ومع ذلك، يصعبُ فصلُ هذه المرحلة عن المرحلة السابقة، أو القول بتحقّق القطيعة بينهما، لأنّ البدايات لم تخلُ من أسئلة مشوّشة جعلتْ القبول في بعض الأحيان مدجّجاً بالشّكّ، بقدرما لم تسلم المرحلة الثانية من حمل بعض سمات المرحلة التي قبلها سواءٌ أكانت فنية أو موضوعاتية، لكنها ظلتْ سماتٍ لم يُكتب لها أن تهيمن، لأن الفرديّ الخاص كان دائما يجاهدُ من أجل تقليص دور الجمعيّ العام إن لم أقل هزمه ومحوه، وإعطاء الذات بشتى تلويناتها مساحةً أوسعَ في النّصّ. وحتى إذا حضَرَ الجمعيُّ العامّ فإنه لا يحضر إلا متسلّلاً مختفياً خلف ستائر دلالاتٍ وصور ورموز تحقُنها الذاتُ بجيناتها الخاصة.
أما في الجزء الأول الذي يضم المجاميع الثلاث الأخيرة فأعزف على مقام القلق، وهو مقامٌ مفتون بالتّخطّي، وتجاوز الذّات وتجاوز الآخر، يمحو ما تقدّم ويخطّ عليهِ صبواتِهِ وأحلامَهُ، فيصبح معها النصّ نصا مفتوحا على المجهول، مشروعاً يتمرّد على أيّ تصميم مسبق، وإيقاعا يتناغمُ مع احتمالاتِ رؤيا تشكّلها الذاتُ الشاعرة أكثر مما يشكلها موضوعٌ حارٌّ أو قضيةٌ كبرى تسيّجُها الأسوارُ الشامخة.
ما رأيناهُ في علاقة المقامين الثاني والثالث من تلاقح وتنافر، يمكننا أن نستشفّهُ في علاقة المقام الأول بالثاني، فأوّلهما يحملُ كثيراً من سمات المقام اللاحق وخاصة الالتفات إلى أهمية الذات دون الوقوع في التقوقع بداخلها، كما يشترك معه في تفعيل شعرية التفاصيل وغيرها، وسبب ذلك يرجع إلى أن محتوى المقامين معا قد استنبت في جغرافية نفسية واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان المقام الأول ينفرد بإخضاع النص لأصوات متعدّدة، وإطالة نَفَسِها وشحْنها بطاقة درامية لا تسلَمُ من حواريةٍ ملحوظةٍ قادتْهُ إلى استثمار الأسطورة وتقنية السيناريو وتأمّل موضوعات قلّما حضرتْ في المقامين الأوّلين مثل موضوع الموت والغربة والعنصرية، وتجاوز صفاء الجنس الأدبي.
ربما كان ثمة سؤال يساور كل من يتصفّح هذه الأعمال أو مثيلاتها هو: ما هو الدافع إلى لمّ مجاميعها ونشرها دفعة واحدة؟ حسنا، لأوضح منذ البداية أن الدّافع لم يكن رغبةً في التّباهي، ولا تقليداً لشعراء مغاربة سابقين سلكوا نفس المسلك، وجُمِعَتْ أعمالهم بمناسبة أو بغير مناسبة، بل كانت هناك دوافع أخرى أوثر أن ألخصها في أربعة دوافع على الأقل كما يلي:
أولها هو الوعي بأن كل ما يُبْدَعُ أو يُكتَب يُعتبر ذخيرة تظل في عُهدة الوطن الذي رعاه وأنجبَ صاحبَه، وفي عهدة أهلِهِ الذين يتلقّونه حاضرا ومستقبلا. لذلك كان من حقّ هذا الوطن على المبدع أن يستودع هذه الذخيرة أمانةً للآتي، تتوارثُها الأجيالُ القادمة جيلاً بعد جيل، للاستدلال على صيرورةٍ قابلةٍ للاستقراء والاستلهام، وقد بات يتحتّمُ على مبدعها أن يصقلها وينقّحها ويتركها سليمة نظيفة مرتّبة قابلة لاستثمار كنوزها والاستمتاع بجمالها.
والثاني هو ما يُلاحظ من حاجة الباحثين في حقل الأدب إلى جمع مدوّنة الشعر المغربي الحديث شأنُهم في ذلك شأنُ الباحثين في الحقول المعرفية والفنية الأخرى. يخامرني هذا الإحساس وأنا أذكر على سبيل المثال أنني طالما تمنيت الكتابة عن شاعر مكناسي رائد هو المرحوم محمد أجانا، لكنني كنت أصطدم كل مرة بصعوبة العثور على نصوصه إذ لا يتوفر منها إلا نصان منشوران في مجلة “آفاق” المغربية.كما أتذكر أن طلبة كثرا طلبوا مني تمكينهم من بواكيري دون أن أستطيع تلبية طلبهم لعدم توفّري على نسخ منها.
والدافع الثالث شخصيّ محض، يتمثّل في حاجة الشاعر في خريف العمر إلى جمع أعماله والعمل على تنقيحها وتصحيحها، بدلا من إلقاء عبئها على غيره بعد رحيله، أو تركها عرضة للنسيان يعيث بها الزمن، وقد لا تجد من يجمعها ويحسنُ إليها. أو أنها تجد من يهتمّ بها لكنّها تُبلبِلُه بما يعتورها من خلط وتداخل وغموض في تبيّن الصّالح من صيغ النصّ الواحد الأجدر منها بالبقاء، إذا عُثِرَ للنصّ الواحد على صيغ مختلفة، وحِيلَ دون الحسم في تعيين النسخة الأحدث منها والجديرة بالبقاء، مما يؤكد أنّ صاحبها وحده هو المؤهّل لقبول واحدة منها واطّراح باقي الصّيغ.
والدافع الرابع والأخير هو تعذّرُ نشر هذه الأعمال من طرف دار للنشر، أو جمعية ثقافية، أو وزارة الشؤون الثقافية لأسباب متعدّدة منها ما هو موضوعيّ يرجع إلى حجم العمل (1440 صفحة) وكلفته المرتفعة التي تحولُ دون تسويقه. ومنها ما هو راجع إلى المناخ الثّقافيّ العامّ الذي يعكّرُهُ ما يسوده من ريعٍ ومحاباة وأنانية وقبلية وولاءات أعرفُ تفاصيلها وأترفّع عن الخوض فيها، مما جعل نية الإقدام على نشرها مغامرة ثقافية صمّمتُ على ركوبها بعيداً عن حساب الرّبح والخسارة.
وأخيراً، إنّ هذه الأعمالَ عصارةُ عُمرٍ، تسْتقي مادّتَها من منابع خيالٍ يحوّلُ العالم إلى صور جميلة، إيماناً منا بأنّ الشّعرَ والحياة مكوّنان لا ينفصلان، من هنا كان الشّعرُ تلخيصاً لتجربةِ الحياةِ بكلّ تناقضاتها وما تشتملُ عليه من عذوبةٍ ومراراة، وما تستلهمُهُ من تجارب شخصية تتضمّن لوحاتٍ بهيةً للأسرة والصّداقة، ومن تجليات للصراع بين الجمال والقبح، ومن قدرةٍ على مسْح الجغرافية وتضاريسها، وتسجيلٍ جماليٍّ ملوّن للخيباتِ الكُبرى ومظالمها احتجاجاً على نفاقِ العالم. لكنّها قد تصير، مع ذلك كلّه، لوحاتٍ تجريديةً تتأمّلُ وجوداً متعدّداً لامرئياً بلغةٍ أقربَ إلى الصّمتِ منها إلى الكلام الصّاخب، تهفو إلى أن تكون حرّة طليقة تحفُرُ مجراها بنفسها لا يخضعُها شكلٌ مسبق، ولا تحنّطُها جُمَلٌ مسكوكة.








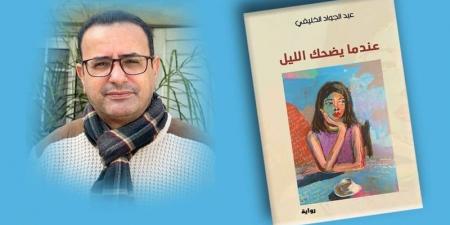



0 تعليق